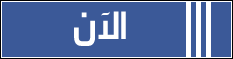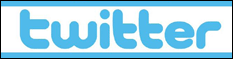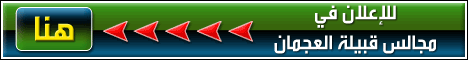| رسالة إدارية |
|
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
:
الأحبة الكرام أعضاء وعضوات و زوار
مجالس قبيلة العجمان الرسمي
:
اسعد الله جميع أوقاتكم بكل الخير و المحبة
:
نحيطكم علماً أحبتنا بأن مجالس قبيلة العجمان الرسمي سوف تغلق مؤقتا
وذلك لعمل تطوير وصيانة للمنتدى.
:
شاكرين لكم جميل تعاونكم معنا
مقدمين الإعتذار لكم جميعا
عن هذا الإنقطاع و الذي هو أولا لتقديم خدمة راقية لكم
لتساهموا في رقي المجالس
:
مع تحيات
:
ادارة شبكة مجالس العجمان
alajmanws@gmail.com
|
الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 12:02 AM .